الصومال والعقود الثلاثة العجاف
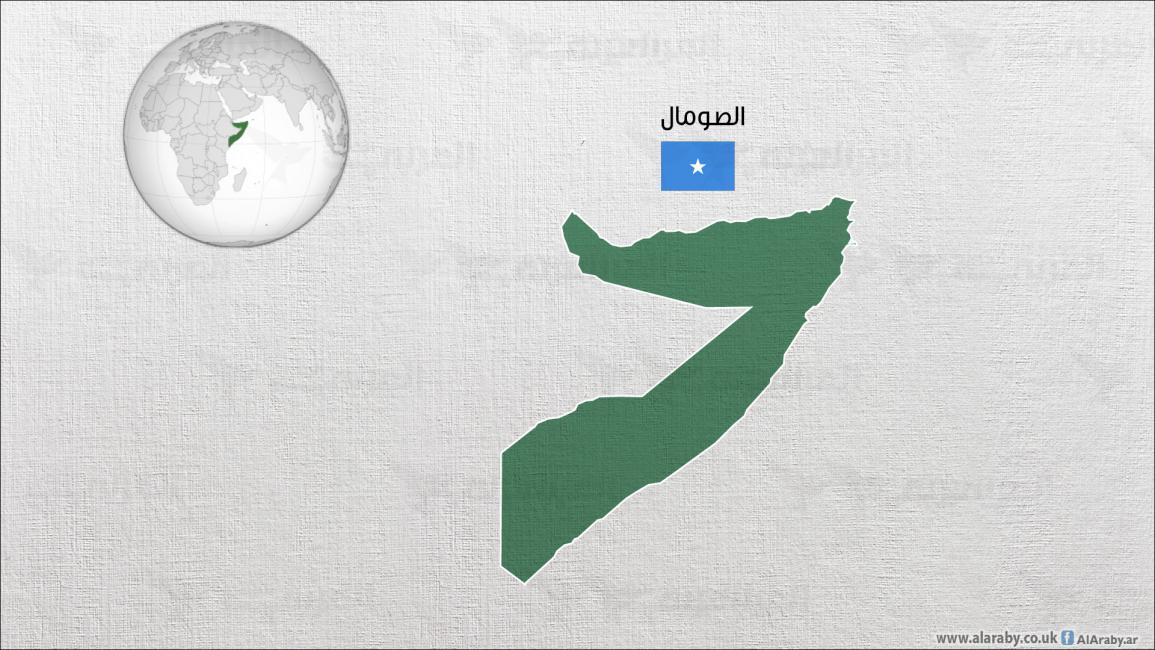
مرّت ثلاثة عقود منذ انهيار الدولة المركزية في الصومال، في يناير/ كانون الثاني 1991، حين انتصرت المليشيات القبلية المسلحة على القوات العسكرية النظامية، وأنهت حكماً عسكرياً استمر عشرين عاماً، لكن الانقلابيين الدمويين لم يحملوا أجندات وطنية وأهدافا واضحة سوى الانقلاب، وإشاعة الفوضى في البلاد، وهو ما حدث؛ حيث نُهبت مرافق الدولة، بما فيها المؤسسات الخدمية، وتحولت، في طرفة عين وانتباهتها، إلى مكاتب خربة تسكنها الكلاب الضالّة، وأحرقت الوثائق الرسمية، ولم يبق منها سوى أشرطة ووثائق قليلة كانت في حوزة أشخاص وأفراد في الدولة الصومالية، لكن سقوط سياد بري لم يورّث الصوماليين نعيماً، بل أدخل البلاد في حالة من البؤس والشقاء وعدم الاستقرار السياسي والأمني، وكأن الشعب الصومالي لا يزال يدفع ثمن سكوته الطويل لإطاحة النظام العسكري (1969-1991).
لم يكن سقوط الدولة المركزية في الصومال حدثاً عابراً، ولا واقعة نزلت من السماء مصادفة، بل كان سيناريو متوقعاً عند الدوائر الغربية والبعثات الدبلوماسية في مقديشو منذ 1989؛ حيث أضحت الدولة الصومالية بمنزلة “الرجل الأفريقي المريض”، تتساقط أوراقها منذ بدأ جنرالات في الجيش ينشقّون عنها، ويشكلون جبهات مسلحة في شمال الصومال وغربيه، ويغيرون على المعاقل العسكرية ومراكز الجيش عند المناطق الحدودية، حتى قويت شوكة الجبهات المسلحة بدعم وتمويل من إثيوبيا والغرب ودول عربية، بهدف القضاء على نظام سياد بري الذي فشلت سياساته داخلياً وخارجياً، وهو ما عكس حالة عزلة تعيش فيها البلاد، عقب هزيمة الجيش الصومالي في الحرب مع إثيوبيا عام 1977، كل هذه الأحداث السياسية والعسكرية قوّضت تماسك بنية الدولة، وقضت على حكم العسكر، وأصبح قادة الجبهات المسلحة يحظون بمزيد من الدعم، كلما ترهّل النظام العسكري داخلياً، حتى سقط آخر حصن له، مقديشو التي تحوّلت مدينة أشباح، وسقط فيها الأبرياء بلا جريرة سابقة، سوى أنهم من عشيرة أصحاب السطوة في النظام العسكري المخلوع، وانتشر السلاح بيد القبائل، وما زال منتشراً، من دون أن تستطيع حكومة صومالية انتزاع آلات الموت هذه من أيدي القبائل ومليشياتها.
ليس الصومال وحده الذي سقط في براثن التفكّك في أوائل التسعينيات، بل سقطت، مع انهيار الاتحاد السوفييتي، دول أفريقية عدة، منها إثيوبيا، لكن المفارقة أن الصومال لم ينهض مجدداً. وعلى الرغم من كل محاولاته للعودة، أعاقت مسار تقدّمه خلافات سياسية وأمنية لا حصر لها، وهو ما يوحي بأن العقل السياسي الصومالي لم ينضج بعد، بقدر ما أن منطق القبيلة وولائها هو الغالب، وعلى الرغم من ذلك فإن بعض العشائر الصومالية نجحت في فرض استقرار اجتماعي وسياسي في أقاليم أخرى في البلاد، مثل بونتلاند وأرض الصومال، بسبب شيوخ القبائل الذين شكلوا ميثاقاً قبلياً للصلح، بينما في المناطق الجنوبية، فشلت القبائل في جمع كلمتها وتأسيس كيان سياسي يمكن الوثوق به، ويقف على مسافة واحدة بين القبائل القاطنة في الجنوب، ويعالج التظلم الاجتماعي، وينهي حالة الفلتان السياسي والأمني، ويعيد سيوف الثأر إلى غمدها.
تكللت، في عام 2001، المصالحة الجيبوتية بين القبائل الصومالية بنجاح، واختير عبد القاسم صلاد رئيساً للبلاد، لكن الحكومة الصومالية لم تدم طويلاً، فوقعت في أنياب (ومخالب) أمراء الحرب الذين أجهضوا حلم الشعب، وأصبح الخيار التوجه نحو كينيا التي نظمت مؤتمر مصالحة جديدا عام 2004، واختير عبدالله يوسف رئيساً، بيد أن الوضع الصومالي ازداد قتامةً بعد تفجر صراع بين القوات الصومالية ومليشيات المحاكم الإسلامية عام 2006، التي لاذت بالفرار أمام توغل إثيوبي اجتاح طول البلاد وعرضها، واستمرت فترة الحكومات الانتقالية عشر سنوات، حتى انتخب حسن شيخ محمود رئيساً عام 2012، وبعدها اعترفت دول العالم بالحكومة الصومالية، وفي مقدمتها أميركا، لتنهي بذلك فترة حكومات انتقالية، لم تورث البلاد إلا أزمات سياسية وأمنية معقدة، ما زالت تأثيراتها جلية في المشهد الصومالي.
بعد تنصيب عبدالله فرماجو رئيساً عام 2017، استبشر كثير من المجتمع أملاً جديداً، ومثّل انتخابه نقطة ضوء من نفق مظلم بعد عقود من الصراعات، حيث كانت وعوده ببناء الجيش وتوفير الوظائف والعدالة للمجتمع تدغدغ مشاعر الصوماليين، لكن كل تلك الوعود تحولت خيبات أمل تسكن الأفئدة، وتريد الخلاص من وحل الخلافات السياسية التي تكاد تهدّد عملية التحول الديمقراطي التي شهدها الصومال في الفترة الأخيرة، حيث كل الطرق التي تؤدي إلى انتخابات شفافة موصدة اليوم، ما يهدّد مسار عملية الانتقال السياسي، ويفرض تدخلاً دولياً من أجل التوصل إلى اتفاقياتٍ جديدة بين الشركاء السياسيين لإجراء انتخابات توافقية.
لعل الدهشة تكمن في أسرار عدم تفاهم القيادات الصومالية في ما بينها، وتلجأ دوماً إلى الخيار الثالث والوسيط الأجنبي، لحل معضلاتها الداخلية، من دون أن تمعن النظر في أوضاع بلادها المتردية، فلا جيش صوماليا قويا يستطيع تسلم المهام الأمنية من القوات الأفريقية، أو حتى يمكن الوثوق به في حفظ المقارّ والمكاتب الحكومية، وخصوصا القصر الرئاسي والبرلمان، والميناء والمطار، فضلاً عن معاناة نحو مليون صومالي نازح في ضواحي مقديشو، الذين يدفعون ثمن خلافات ساستهم ردحاً من الزمن.
اللافت أن دولاً أفريقية نجحت في لملمة جراحها إثر سقوطها المدوي، وذلك بعد إجراء معالجاتٍ جذريةٍ لباطن أزماتها السياسية والأمنية؛ فحتى الآن لم تنجح في الصومال جهود المصالحة بين قبائله، كما لم تنجح عمليات بناء الجيش الصومالي المفكّك منذ ثلاثة عقود، ولم تُستكمل أيضاً كتابة الدستور الذي تستمر أعمال صياغته منذ عشر سنوات، ناهيك بغياب محكمة دستورية لفصل الصلاحيات وحسم المواضيع الجدلية والقانونية بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية، فمع وجود تلك الإشكالات، يبقى الصومال جسداً ضعيفاً لا يقوى على مجابهة تحدّياته الأمنية وحسم خلافاته السياسية، كما أن النظام الفيدرالي بات في نظر خبراء عديدين مجرّد آلية لإضعاف الصومال وتفتيته، بدل أن يكون حبل نجاة لانتشاله من قاع الأزمات.
في النهاية، يبقى الوضع السياسي والأمني في الصومال ملغوماً بالتحدّيات الداخلية والخارجية، وربما يشبّه بعضهم الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد من خلافاتٍ سياسية عميقة، بأوائل التسعينيات من القرن الماضي، وربما ينفجر الوضع أكثر، إذا لم تنجح الجهود الدولية في التوصل إلى حل وسط يمكّن الصومال من تنظيم انتخاباتٍ شفافة، لنقله إلى بر الأمان، فهل ينزلق هذا القطر العربي إلى فوضى جديدة، ليقطع شوطاً جديداً عمره عقود أخرى للتعافي، أم سيتعظ الصوماليون هذه المرة، ويوقفون فرامل خلافاتهم السياسية، ليحلّ الوئام والتفاهمات، بدل النعرات والمؤامرات الكيدية؟





